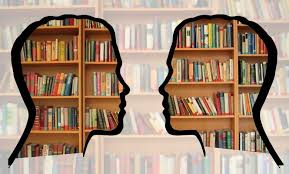المستهلك في التجارتيْن التقليدية والإلكترونية: كيف يراه فقهاء القانون؟ (مغرب التغيير – الدار البيضاء 13 أبريل 2024)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 13 أبريل 2024
إلحاقاً بالمقال السابق، والمتعلق بالمنظور الأممي للمستهلك بوصفه أحد أطراف التعاقد التجاري، نستعرض أدناه التعاريف السائدة لدى أهل الاختصاص والتخصص من الباحثين والدارسين في مجالات الاقتصاد والقانون، وذلك من باب إلقاء الضوء على شأن اقتصادي/اجتماعي، وإنساني، قلما يَلقى ما يستحقه من الاهتمام لدى عامة المتلقين، الذين لا ينتبهون عادة إلى ذلك إلاّ بعد نشوب النزاعات والمخاصمات بين بعض أو مختلِف أطراف العلاقات التجارية، التقليدي منها والإلكتروني على السواء.

يُعتبَر المستهلك الحلقة الأضعف في سلسلة العلاقات التعاقدية سالفة الإشارة، ولذلك فهو المعني الأوّل بالحماية القانونية، التي تهدف إلى تمتيعه بضمانات من شأنها أن تحافظ على حقوقه وتصون مصالحه من الضياع، وكرامته من الهدر. ونظراً لهذه الأهمية، التي يستأثر بها المستهلك، نرى من الأجدر أن نتناول تعريفه من جوانب بحثية مختلفة.
التعريف الفقهي للمستهلك
في بدايات النصف الثاني من القرن الماضي فقط، بدأ الاهتمام بالمستهلك لدى فقهاء القانون، بعد أن كان مقصوراً في دائرة علماء الاقتصاد دون غيرهم. غير أن الموضوع لم يلبث أن تحوّل إلى ظاهرة مستأثرة باهتمام الباحثين والدارسين في مجالات الفقه والقانون، خاصة على إثر بداية ظهور “حركات الدفاع عن المستهلكين”، بعد ظهور هذه الفكرة في أول الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية، ليتحوّل الموضوع إلى شغل شاغل في معظم بلاد المعمور.
بيد أن انتشار التعاطي لهذا الموضوع الجدلي، واتساع رقعة تداول مصطلح “المستهلك” داخل البلدان النامية بالذات، أثار أشكالاً من الجدال الحاد بين مختلف الفرقاء الاقتصاديين والفاعلين الاجتماعيين وفقهاء القانون، مما طرح في الساحة مفهوميْن مختلفيْن للمستهلك، أحدهما موسّع، وثانيهما ضيّق.[1]
- التعريف الموسع:
يقصد بالمستهلك حسب هذا التعريف “كل من يبرم تصرفا قانونياً من أجل استخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصية أو في أغراضه المهنية”.[2]
ويطمح القائلون بهذا التعريف إلى تمديد قانون الاستهلاك ليشمل بحمايته الأشخاص الذين يتصرفون لغرض مهني، وكذلك خارج اختصاصهم المهني. مثال ذلك: التاجر الذي يقتني جهازَ إنذار لحماية محله من الاقتحام والسرقة. غير أنّ ما يؤخذ على هذا المنحى، أنه يفرط في توسيع الدائرة الدلالية للمصطلح، مما يشكّل نوعاً من الارتباك في المفاهيم يجعل مطلب الحماية المراد تكريسه قانونياً للمستهلك صعب المنال.
- التعريف الضيق:
يقصد بالمستهلك في المفهوم الضيق:” ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يحصل أو يستعمل منتجات لأغراض غير مهنية”.[3] ويرى القائلون بهذا التوجّه، أن المستهلك هو مَن يطلب حاجته من المنتجات والخدمات لكن لاستعمالاته الخاصة، ويستندون في ذلك على أن المتدخل الاقتصادي، بمعنى الطرف الآخر في عقد الاستهلاك، يكون أقدر على الدفاع عن نفسه مهما خرج عن مجال اختصاصه، لأنه بعكس المستهلك يمتلك خبرة وحنكة مهنيتيْن لا تتيسّران لهذا الأخير.[4]
يمكن أيضاً أن نلاحظ من خلال هذا التعريف الضيق أن المستهلك يُفترَض أن تنتفيَ لديه أي نية مسبقة في المضاربة أو البيع أو غيرهما، وفي الوقت ذاته نجده لا يتوفّر على المعرفة التقنية بما يسعى لشرائه والحصول عليه، ويُعَدُّ هذا من عوامل ضعفه وقلة حيلته.[5]
انطلاقاً منه، يمكن أن نعرّف المستهلك بالقول إنه المُقتنِي الذي “يقوم باستعمال السلع والخدمات لإشباع حاجياته الشخصية، وحاجيات من يعولهم، وليس ﺑﻬدف إعادة بيعها، أو تحويلها، أو استخدامها في نطاق نشاطه المهني“.[6]
التعريف التشريعي للمستهلك في القانون المقارن
يُشار، على سبيل المقارنة والاستئناس، إلى أنه جاء تعريف المشرع الفرنسي للمستهلك بموجب نص المادة 1649 من القانون المدني الفرنسي بكونه “كل شخص طبيعي يتعاقد من اجل أغراض لا تدخل ضمن نشاطاته المهنية أو التجارية” والملاحظ في هذا التعريف أن المشرع الفرنسي تبنى “المفهوم الضيق” في تعريفه للمستهلك، على غرار ما ذهب إليه أغلبُ التشريعات الوضعية في مختلف الدول.[7]
أما المشرع اللبناني فقد عرّف المستهلك من خلال قانون حماية المستهلك بأنه “الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها وذلك لأغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني“.[8] ويُلاحظ في هذا التعريف أنه أكثر اتساعا من نظيره الفرنسي ولكن بشكل نسبي، لكونه ترك هامشا يسيراً يمكن أن تندرج فيه أغراض “غير مباشِرة” للنشاط المهني.
وفي التشريع المغربي تنص المادة 2 من قانون حماية المستهلك على أن هذا الأخير هو “كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي“. ويلاحظ في هذا التعريف نوع من التكرار، لأنه يتحدّث عن تلبية “حاجيات غير مهنية” ثم يعود للتأكيد على “الحاجيات الشخصية أو العائلية”، وقد كان يكفي التنصيص على إحدى الصيغتيْن ما دام الاستعمال الشخصي أو العائلي في نظرنا هو جزء من الحاجيات غير المهنية للمستهلك.
يُلاحظ أيضاً أن الاستعمال “غير المهني” يمكن أن يكون من طرف شخص آخر خارج الدائرة “العائلية”، كما هو الحال بالنسبة لمن يشتري لفائدة مؤسسة خيرية أو لفائدة شخص معوز من الجيران أو المعارف. ولهذا فتعبير “العائلي” يمنع المستهلك من هذا النوع من الاستعمالات “غير المهنية”، وفي هذا تقييد غير مبرَّر لحريته في التصرّف في مقتنياته ومن شأنه أن يجعل موقفه ضعيفاً أمام القانون في حالة نشوب نزاع أو نحوه.
ونسجل بهذا الخصوص، من خلال القانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك، أنّ المشرّع المغربي لم يدرج مصطلح “غير المهني” إلى جانب مصطلح “المستهلك”، وكذلك لم يعتبر “الطرف المهني” الذي يتعاقد خارج مجال تخصصه لفائدة مشروعه أو مهنته مستهلكاً. وخلاصة القول، “إن المشرع المغربي تبنى مفهوما وسطيا للمستهلك بين المفهومين الضيق والواسع حيث أقحم الأشخاص المعنويين في مجال الحماية لكنه أكد على الاستعمال الشخصي أو العائلي“.]9[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]_ الطيب محمد الأمين ،الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك ،دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص ، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ، 2007 /2008، ص14
[2]_ بودالي محمد، “حماية المستهلك في القانون المقارن”، دار – الكتاب الحديث ،الجزائري ،بدون رقم الطبعة بدون، سنة الطبع، ص 22.
[3] _ أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية المستهلك إزاء المضمون العقدي ، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون رقم الطبعة، 1994، ص44.
[4] _ بودالي محمد ، حماية المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص 24
_[6]عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الجزء الأول ،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،بدون رقم الطبعة، 2002 ، ص 34.
[7]_بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، دار الفجر للنشر و التوزيع، الجزائر، بدون رقم طبعة، 2005، ص 25.
[8] _ نفس المرجع ، ص 25.
[9] “حقوق المستهلك في إطار القانون المغربي 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك” إعداد: عبد الرفيع علوي باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بأكادير (ديوان الموثق العصري الأستاذ منتصر بلحاج، أكادير 2016).