تقييم اللجان المختصة بوزارة التربية الوطنية لأحوال المنظومة التعليمية في خضم خطط الإصلاح السابقة (مغرب التغيير – الدار البيضاء 11 يوليوز 2024)
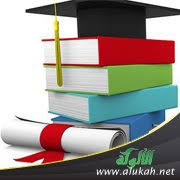
مغرب التغيير – الدار البيضاء 11 يوليوز 2024 ع.ح.ي.
الآراء والأفكار المعبَّر عنها في هذا الباب لا تُلزِم هذه الجريدة
إلحاقاً بالمقالين السابقين، وفي غمرة التغييرات التي طرأت بشكل متوالٍ على خطط وبرامج إصلاح المنظومة التعليمية، كانت الوزارة المعنية قد أنشأت “لجاناً متخصصة” أوكلت إليها دراسة الوضعية السائدة وإنجاز تقرير تقييمي يضع اليد على الاختلالات التي يشهدها هذا القطاع، والتي لا تختلف إلاّ في بعض التفاصيل الصغيرة فيما بين كل تجربة إصلاحية وأخرى. وفيما يلي بعض مما انتهت إليه اللجان المختصة سالفة الإشارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تحوّلات طفيفة ربما طرأت على هذه الوضعية مع تبدّل الخطط، وخاصة مع ظهور ما يسمى الآن بـ”الخطة الاستراتيجية” أو العشرية الإستراتيجية 2020/2030، وظهور ما يسمى أيضاً بـ”القانون الإطار”.

- التكوينات غير الملائمة:
إن الأخذ بالمناهج التربوية الجديدة، من منطلَق المدخل المُعتَمَد، قد شُرِعَ في تنفيذه قبل إعداد الأطر التربوية من قيادات ومدرّسين لوضع هذا التغيير على أرض الواقع، وهذا ما أقرّت به لجان الوزارة المكلفة بالمتابعة والتقييم.
إننا هنا بإزاء سلوك “إصلاحي” في غاية الغرابة، ولا يقل غرابةً عن سابقةِ الشروع في تدريس اللهجات الأمازيغية في الأقسام الصغرى، دون التوفر على وسيلتيْن رئيسيتيْن هما: الأساتذة المؤهلون لهذه العملية؛ والكتب المدرسية المتعدّدة والمتنوِّعة، والمحترِمة بالتالي لمطلب تكريس الخصوصيات الثقافية الجهوية والإقليمية والمحلية.
والواقع أن غياب التكوين المستمرّ لا يزال بمثابة العقَبَة الكَأْداءِ في جميع مناحي الإصلاح، وليس على الصعيد المنهجي المذكور وحده. وهذا، للأسف الشديد، ظلّ مطروحًا بإلحاح منذ أولى التجارب الإصلاحية الماضية، وقد يبقى كذلك إلى ما شاء الله، دون أن نملّ تكرار نفس المقولة التي صارت مؤبَّدة: «عدم مواكبة التكوينات المستمرة لخطط وبرامج الإصلاح المسطرة». فإلى متى تظل هذه التكويناتُ دون المستويات المطلوبة كمًا وكيفًا؟ وكيف نتوقَّعُ للتجربة الإصلاحية الحالية أن تُفضيَ إلى نتائج أحسَنَ، بنفس مناهج التكوينيْن الأساسي والمستمر، وبنفس المصوغات القديمة، ونفس المنظور التقليدي للعلاقة بيْن مختلِف مكونات المجتمعات المدرسية، وفي طليعتها أطرُ هيأة التدريس؟
- عدم تحيين الكتب المدرسية:
إن الكتب المدرسية لم تعرف بدورها نفس المواكبة للمنهاج الدراسي الجديد، بل بقِيَتْ على حالها، وفي نمطها التربوي المطبوع بمعايير التجارب الإصلاحية السابقة. وهذه مفارقة أخرى لا تقلّ غرابةً عن سابقتِها، إذْ كيف يتغيّر المنهاج الدراسي دون إجراء التغيير ذاته بكل مقاييسه الجديدة على الكتاب المدرسي؟!
إن هذه المفارقة، والتي سبقتها، تدعوان إلى طرح السؤال المحرج حول مدى جدّية القول بالإصلاح، إذا كان هذا الأخير في منتهى الإعاقة، بلا قوائم وأطراف (الأطر المكوَّنة والمؤهَّلة)، وبلا وسائل خارجية يمارس بها فعلَيْ الكينونة والحياة (الكتب المدرسية)، هذا إذا سلَّمنا بأن له روحًا يجسِّدها المنهاج الجديد؟
- عدم الاقتناع بجدوى التغيير المقترَح:
إنّ «تضارب الآراء حول جدوى التخلي عن الممارسة البيداغوجية المبنية على مبدأِ “التدريس بالأهداف”، لفائدة الممارسة البيداغوجية المبنية على التربية على القيم، وعلى تنمية الكفايات والتربية على الاختيار واتخاذ القرارات، كما جاء في النقطة الثالثة من تقييم اللجان المختصة، يُقدّم الدليل، هو الآخر، على أن الطفل هو آخر ما ينشغل به “الإصلاحيون”، إذْ كيف يُعقَلُ أن نشْرَعَ في تنفيذ منهاج دراسي جديد، في إطار برنامجٍ إصلاحيٍّ قائم، بينما لا يزال النقاش محتدِمًا حول جدوى هذا المنهاج، ولا تزال الآراء متضاربةً بيْن مَنْ يقبل الأخذ به، ومَنْ يتمسّكُ بالمنهاج القديم لعدم ثقته في نفعية التغيير المقترح؟ وكيف يتسنى لبرنامج إصلاحي أن يُثبِتَ جدواهُ والقيِّمون عليه منقسمون بيْن قابلٍ ورافض، ومنضبطٍ ومُمْتنع؟!
وهل يجوز أن نتذرّع بوجود جيوب للمقاومة داخل هياكلنا التنفيذية تُعيق تنفيذ البرامج الإصلاحية المسطَّرة، ولا نجد أيَّ حرجٍ في الإقرار بذلك على هذا الصعيد الرسمي؟ ألا يُعتبَرُ ذلك اعترافًا صريحًا بعجزنا عن السيْر في طريق التغيير إلى نهاياته؟
إن الذي يدفعنا إلى هذه التساؤلات، هو كَوْنُ ذلك التضارًب لم يحدُث أثناء مراحل التخمين والدراسة والمناقشة والتخطيط والبرمجة، بل وقع ولا يزال يقع على مستوى التنفيذ، مما يوحي فعلاً بوجود مقاومة للتغيير توشك أن تجعل جهودنا الإصلاحية زائدةً عن الحاجة، وهذا في منتهى العبث والخطورة.

نقول العبث، على صعيد الالتزام الحكومي بتنفيذ مخططات الإصلاح وبرامجه؛ ونقول الخطورة، على مستوى مصير الطفل، الذي يبقى على نفس الحالة من الضياع بيْن مَنْ يُريد أن يفعل ومَنْ يمتنعُ عن الفعل؛ وبيْن من يلتزم بالخيارات السياسية للدولة (الوزارة) ومَنْ يتنكَّرُ لها من الداخل… وليس هذا إلاّ ضربًا من العبَث.
- التشكيك في نجاعة المناهج الجديدة:
إن القول بظهور تفسيرات غريبة تُشَكِّكُ أطُرَ هيأة التدريس في جدوى المدخل التربوي الجديد، يَفضحُ هو الآخر ضعفًا شديدًا في قدرتنا على الإقناع بمزايا الإصلاحات المقترحة.
إنّ هذا العجز، كما نرى، تشكو منه العلاقة بيْن السلطة التعليمية وموظفيها (الأساتذة)، مما ينم عن وجود خلل كبير وعوائق غير هيِّنة فوق جسر التواصل الذي يُفتَرَض أن يكون ممدودًا وسالِكًا بين هذيْن الطرفيْن.
إنّ الأساتذة، بالذات، هم أوّلُ مَنْ ينبغي إقناعُهُم بالضرورة، لأنهم المُنَفِّذون الحقيقيون لمضامين المنهج الجديد، فضلاً عن كونهم صلةَ الوصل الأولى والأخيرة بيْن هذا المنهج والطفل المتمدرس، الذي يبقى، والحالة هذه، شبيهًا بفئران التجارب المخبرية، كما يقول واقع الحال، وبعيدًا بالتالي عن أن يكون، بالفعل، في صميم الجهد الإصلاحي القائم.
- غياب المناصب المالية اللازمة:
إن التحَجُّجَ، أيضًا، بعدم توفُّر المناصب المالية الكافية لتنفيذ الشق الإصلاحي المتعلق بإدماج الإعلاميات في مشروع التلميذ، يبعث بدوره على الاستغراب، لأنّ الأمر يتعلّق بقطاع أقبل، في إطار “المغادرة الطوعية”، على التفريط في ألاف مؤلَّفة من الأطر المؤهَّلة والمحنّكة، والتي لم يكن استثمارُها يتطلب أيَّ مناصبَ ماليةٍ جديدة، بل لم يكن يتطلّبُ إلاّ القليل من بُعدِ النظر، ومن الجدّية في التعامل مع مجال اجتماعي يعرف الجميع أنه متحرِّكٌ باستمرار، وأنه مُرشَّحٌ للإصلاح والتغيير والتعديل بلا هوادة. وهذا يَفترِضُ أن يكون هذا القطاع آخر مَنْ يستغني عن أطره مهما كان الثمن وكانت المبرِّرات.
إننا هنا بإزاء موقف مكمِّلٍ في غرابته لكل المواقف السابق نقدُها أعلاه، حيثُ يُقدِّم لنا برنامجًا للإصلاح والإدماج أُعطِيَت الانطلاقةُ لتنفيذه دون أن تتوفر له المناصب المالية اللازمة لمدّه بما يحتاج إليه من أطر التنفيذ.
إن هذا يمكن اعتبارُهُ استخفافًا من طرفنا بالأطفال المتمدرسين، الذين يجدون أنفسهم في مثل هذه الحالات، وما أكثرها، أمام برامج دراسية منقوصة، بأساتذة مُفتَقَدين، وبتوزيعات زمنية سريالية، لأنها تشتمل على مواد بلا مدرّسين، ليس لغياب هؤلاء لسبب أو لآخر، بل لعدم توفر المناصب المالية لتوظيفهم أساسًا… وهذا غير معقول، لأن المعقول يفترِض أن لا تُبرمَجَ إلاّ المواد المتوفرة على ملقِّنيها، وبالتالي على مناصب هؤلاء المالية، وليس غير ذلك بتاتًا!
- الافتقار إلى أساتذة الفلسفة:
إنّ “محاولة التراجع عن تعميم الفلسفة في الثانوي التأهيلي”، كما ورد في التقييم أعلاه، قد فرضها هي الأخرى عدمُ توفُّر العدد الكافي من الأساتذة الحاملين لهذا التخصُّص. وقد سبق لنا التعقيب على هذا الخصاص في الأساتذة المتخصِّصين، الأمر الذي يعود بنا إلى طرح السؤال عن الأسباب التي أدّت إلى تفاقُم هذه الظاهرة في مختلِف الأسلاك، بعد نحو خمسين سنةً من العمل على إرساء أسس المدرسة المغربية.
إنّ هذا أمرٌ واقع، مع العلم بأن الشباب حاملي الشهادات الجامعية، والمتظاهرين بيْن كلِّ يومٍ وآخر أمام مبنى البرلمان، ينتمي عدد كبير منهم إلى شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع، وإلى مواد أخرى متآخية، وفي وُسْع التوظيفات الجديدة والمتاحة أن تحلّ جزءًا كبيرًا من هذه المسألة إذا بذلْنا القليل من الجهد في انتقاء الخرّيجين المناسبين والمطلوبين.
إنّه لا يُعقَل أن نشكو من الخصاص في مادة الفلسفة، في الوقت الذي نقومُ فيه بتوظيفات جديدة لا تبحث في اختيار خريجي هذه الشعبة بالذات، بينما يبقى هناك سؤال آخر في غاية الإحراج: «كم من أساتذةٍ للفلسفة تم الاستغناء عنهم في إطار المغادرة الطوعية عير المأسوف عليها؟».

- انعدام المساواة بيْن أعضاء هيأة التدريس:
إن «الإبقاء على امتيازات غير مقبولة لفئات من الأساتذة»، كما يقول التقرير، يزيد في تعميق الفوارق بيْن أفراد هيأة التدريس، ويؤدّي بالتالي إلى نتيجتيْن حتميتيْن: تزايد التذمّر والاحتجاج بيْن صفوف أطر هيأة التدريس؛ وتراجُع مؤشرات المردودية والجودة في أداء الفئة المغبونة من هؤلاء. ولن نحتاج إلى القول من جديد، إن التلميذ هو المتضرِّر الأكبر من هذا النوع من التعامل مع أطرٍ هم بدورهم في أمسِّ الحاجة إلى التفهّم والرعاية.
- عدم الاقتناع بأسلوب تدبير الامتحانات:
إن القول بـ «إخضاع تحديد مواد الامتحانات الموحدة الجهوية والوطنية لمنطق غير مقنع ويحتاج إلى نقاش هادئ»، كما ورد في آخر نقطة من التقييم الذي أنجزته اللجان الوزارية المختصّة، يعني أننا، ونحن ننظم الامتحانات الدورية والسنوية، نُقِرُّ بعدم صلاحية طريقة تدبيرنا لها، والتي يصفها التقرير بـ«غيْر المُقنِعة»، ويتمنى الدخول في «نقاش هادئ» من أجل التوصُّل إلى صيغة تدبيرية جديدة تكون هذه المرة مُقْنِعة، ولعل هذا لا يحتاج إلى مزيد تعليق.
كانت هذه، إِذَنْ، هي النتائج التي انتهى إليها التقييم الذي أنجزته لجان وزارة التربية الوطنية، المكلفة من لدُن هذه الأخيرة بالوقوف على خلاصات التجارب الإصلاحية السابقة. وكما رأينا ذلك، وبشهادة صريحة من اللجان ذاتها، نكون بصدد تنفيذ برامج إصلاحية نعلم أنها منقوصة من عدّة أطراف ربّما نخصص لها في المستقبل القريب مقالاً آخر على انفراد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: قاعة الانتظار، أرشيف مغرب التغيير / صورة الواجهة: شبكة الألوكة.





