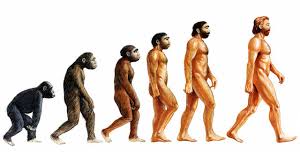“إنكار الترادف في اللغة”: فعل يسير.. ولكن أثرَه خطير!! (مغرب التغيير – الدار البيضاء 19 يونيو 2024)
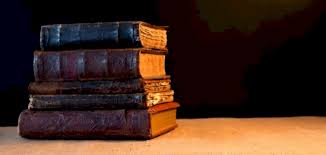
مغرب التغيير – الدار البيضاء 19 يونيو 2024 ع.ح.ي.
الآراء والأفكار المعبَّر عنها في هذا الباب لا تُلزِم هذه الجريدة
قبل الدخول إلى هذا المجال المعرفي الشائك، تعالوا ننظر في مسألة “الترادف”، وفي أساسها كظاهرة لسانية كونية، باعتبار نشوء اللغات وتَعَدُّدها واختلافها وكذا تَمَتُّعها بالحياة، ككل الكائنات الحية، ظاهرة كونية بامتياز، وبالتالي يخضع لها كلُّ لغات العالم… فكيف إذن تولد اللغة؟
إن اللغةَ، أيَّ لغة، وكذلك كلماتِها وألفاظَها، إنما هي وليدة الحاجة إلى التعبير، ما في ذلك أدنى شك. وبالتالي فإن الكلمة في كل لغات العالم لا يتم إحداثها إلا للتعبير عن فعل من الأفعال أو شيء من الأشياء أو ظاهرة من الظواهر التي تعج بها الحياة الإنسانية.
ينجم عن هذا المفهوم، أن الكلمة في كل لغات العالم تظل حية بلا توقف، ما دام الفعل الذي تدل عليه أو الشيء الذي تشير إليه باسمه قائما ومستمرَّ الحضور في حياة المتكلم، ولكنها قد ينتابها عجز عن مسايرة تطور الأشياء والكائنات والظواهر فتصير الحاجةُ ماسةً إلى ابتكار كلمة جديدة وبديلة لا تحل أبداً محل سابقتها، وإنما تأتي مواكِبة لتطور الفعل أو الشيء او الظاهرة التي كانت تشير إليها الكلمة السابقة، والتي كانت معبرة عنها قبل خضوعها لسُنّة التطوّر، وبذلك تتعايش الكلمتان السابقة واللاحقة للدلالة على أمرين صارا مختلفين، أحدهما أصيل، وثانيهما عبارة عن شكل متطوّر لِسابِقِه، وبذلك أيضاً، يتحقق إغناء اللغة المعنية وتوسيع رصيدها من الألفاظ والأفعال والأسماء…
هنا لابد لنا من الوقوف ببالغ الانتباه عند الملاحظة المبدئية التالية، ونقول “مبدئية” لأنها ستتوقف عليها أحكام من شأنها أن تغيّر بنسبة 180 درجة مفهوم “التشابه” بين الكلمات، في إشاراتها وتسمياتها للأشياء وفي معانيها، والذي نطلق عليه اختصاراً وصف “الترادف”:
إن هذا التطور في الأفعال والأشياء، وبالتبعية في الكلمات المعبرة عنها، أو المشيرة إليها على سبيل التسمية، هو الذي يجعل “الترادف” غير وارد إلى حد الاستحالة… فكيف ذلك؟
سنأخذ مثالين اثنين يَسيرَيْن من صميم الواقع حتى نخرج من جُبّة التنظير المعنوي إلى المعايشة الملموسة:
المثال الأوّل: أننا حينما نعبّر عن فعلَيْن مثل “دخل” و”ولج”، فإنه يتبادر إلى ذهننا للوهلة الأولى معنى “الدخول”، وهو المعنى العام الجامع لفعلين متشابهيْن أو بالأحرى “متآخيَيْن”، ولكنه تشابه ظاهري فحسب، ولا يصل التشابه فيهما إلى درجة التطابق والتماثل. فالأول كان مستعمَلا في فترة تاريخية معينة لم تكن الحاجة فيها واردةً إلى فعلٍ ثانٍ يشير إلى “دخول من نوع جديد” لم يعد الفعل الأول قادرا على التعبير عنه، كالدخول “إلى المعلومات” على سبيل المثال. هذا مثال أول، وهو من البساطة بمكان.
المثال الثاني: أننا حين نورد فعلَيْ “خرج” و”مرق”، فإننا نلاحظ أنهما يدلاّن في العموم على فعل “الخروج”، ولكن أوّلهما مادي فيزيقي، كالخروج من المعمل أو المكتب، بينما الثاني أكثر تجرداً ومعنويةً كالخروج من العقيدة أو الديانة أو التقاليد والأعراف التي تميّز المجتمع أو الجماعة…
هذا يجعلنا نفهم، بسهولة، كيف أن الفعلين في المثال الأول وكذا نظيريْهما في المثال الثاني يستحيل أن يكونا مترادفيْن، وذلك لأن الفعل الثاني في المثالين معاً لم يأتِ إلى اللغة إلا بعد أن عجز الفعل الأول عن التعبير عن شكال جديد ومُغايِر من “الدخول” او “الخروج”… وهذا هو الذي يؤكد وجه الاستحالة، الذي نحن بصدد إثباته والتأكيد عليه.
بهذا المفهوم اللساني، يستحيل علينا القول إن فعلَيْ “الدخول” و”الولوج” فعلَان مترادفان، بمعنى يفيد التماثل والتطابق؛ وكذلك الشان بالنسبة لفعلَيْ “الخروج” و”المروق”.
هناك أمر مبدئي هو الآخر وبالغ الأهمية: فاللغوي لا يجوز له أن يستنبط أو يصنع كلمة جديدة إذا كانت ستدل دلالة تماثلية وتطابقية على نفس المعنى الذي كانت تدل عليه سابقتها، التي من العبث أن نزيد عليها كلمة أخرى تؤدي ذات المعنى مائة في المائة، لأن ذلك سيشكل تكراراً وحشواً من شأنهما أن يُفسدا جمالية اللغة وينزعا عنها لباس الموضوعية. فما دامت الكلمة المتوفرة لدى اللغوي قادرة على أداء دورها كاملا فلا حاجة له مطلقاً إلى الإتيان بكلمة أخرى تُماثلُها وتُطابقهاً كل التماثل والتطابق، وتحقق معها بالتالي مبدأ “الترادف”، فذلك مرة أخرى سيكون من باب الحشو والعبث!!
إن “الترادف” إذَنْ لا وجود له في أي لغة من اللغات بلا أدنى استثناء، لأن المبدأ الأساس في نشأة الكلمات هو ذاته في كل لغات العالم، وهو مبدأ إنساني كوني من الثوابت.
نأتي الآن إلى الإجابة على سؤالنا، حول العلاقة التي نراها قائمةً بين “نفي الترادف” من جهة، وبين ما سمَّيْناه “أثراً خطيراً” من جهة ثانية.
إننا نروم هنا طرح مقولة سيراها البعض غريبة، ولكننا سنحاول الاستدلال على صوابها خطوةً خطوة:
تفيد هذه المقولة أن “القول بعدم وجود ظاهرة الترادف من شأنه أن يهدم قواعد غير قليلة وغير هيّنة في الفهم والقول والممارسة”، وسنضرب للدلالة على ذلك مثلاً مزدوجاً ذا صلة بميراثنا الفقهي الإسلامي، وسنرى أن “نفي الترادف” سيضرب جزءاً كبيراً، حتى لا نقول الجزء الأعظم من ذلك الميراث في الصفر… فكيف ذلك؟!
مرة أخرى، سنلجأ إلى مثالَيْن ملموسَيْن ويَسيرَيْن لتقريب الصورة والفكرة بشكل أمثل:

المثال الأول:
جرى بين فقهاء الشريعة حُكمٌ مُجْمَعٌ عليه، أو بالأحرى، كان مُجْمَعاً عليه قبل ظهور الفكر التنويري الآخذ حالياً في الانتشار والتوسّع، بقطع “يدَيْ” السارق والسارقة بالمعنى الذي يفيد “البتر”، لأن أولئك الفقهاء وشيوخهم اعتبروا فعلَي “القطع” و”البتر” مترادفَيْن، دون أن يبحثوا في تجلياتهما في آيات الذكر الحكيم، لأنهم لو فعلوا ذلك بتَدَبّر لأدركوا أن القرآن لم يَرِدْ فيه فعل “القطع” بتاتاً بمعنى “البتر”، وذنبهم في ذلك أنهم لم يرتّلوا القرآن ترتيلا كما أمرهم الله عزّ وجلّ، لأنهم اعتبروا أيضاً أن فعل “الترتيل” مرادف لفعل “التجويد” أو “التنغيم”، بينما “الترتيل” استخراجٌ للآيات المتطرقة لذات الموضوع، أو ذات الكلمة، للوقوف على معناها في مختلف الآيات، ومن مختلف الجوانب، وهذا هو “الترتيل”. ولو كانوا لجأوا إليه في تفسيرهم لحد السارق والسارقة لوجدوا ان القطع في القرآن دل دائما على “فصل معنوي” وليس “بتراً مادياً فيزيقياً ملموساً”. فهناك قطع الطريق، وقطع الأرحام، وقطع الكلام، وقطع الوادي أو النهر… ولأدركوا أنه لا مكان في الكتاب الحكيم للفظ “القطع” بمعنى “البتر”، وبالتالي فإن قطع “أيدي” السارق والسارقة ليس معناه سوى “قطع دابر السرقة” عنهما، بواسطة إحدى الوسائل المتاحة في كل عصر، كإيداعهما الإصلاحيات أو السجون، أو تكوينهما مهنياً وتدبير أيّ شغلٍ لهما يسترزقان منه… وبذلك تكون “أيدي” السارق والسارقة قد قطعت كلياً وعملياً عن السرقة.
وإن الذي يؤكد هذا المعنى الحضاري، والرحيم، لَهو قول الله تعالى ” فاقطعوا أيدِيَهما” بالجمع، ولو كان الغرض “بتر” يدٍ واحدة لكل منهما كما يقول الفقهاء لقال، “يديْهما” بالمثنّى، بمعنى يد لكل واحد منهما، وهذا بالغ اليسر والوضوح، لولا أن مفسرينا نقلوا عن بعضهم البعض دون رجوع إلى القرآن لتدبر آياته وتمحيص تراكيبها ومعاني كلماتها!!
المثال الثاني:
جاء في القرآن الحكيم ذكر “الرجم” بمعنى الطرد والنفي والإبعاد، ولكن المفسرين اعتبروا الرجم رديفاً “للرشق” بالحجارة، ولذلك استسهلوا نسخ الآية القرآنية القاضية بجلد الزانية والزاني مائة جلدة، واستبدلوها برواية لحديث نبوي مختلَف عليه يقضي بالرشق بالحجارة حتى الموت، وبذلك ارتكبوا بسبب هذا “الترادف” المفترَى عليه إثمَيْن عظيمَيْن وفظيعَيْن هما، على التوالي:
- محو “حكم إلهي”واستبداله “برواية بشرية” عن فلان عن علاّن؛
- الحكم على الزانية والزاني بالقتل رشقاً بالحجارة، في حين ان رب العزة أراد فقط أن يُذيقَهما العذاب بالجلد، وأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليذوقا أيضا آلام الفضيحة والسُّمْعة السيّئة، وهذه أشد إيلاما من الضرب بالسياط الجِلدية!!
وكما نرى في المثالين معاً، فإن الإقرار بنفي الترادف من شأنه فعلا أن يغيّر الشيء الكثير في أحكام فقهية مبنية على ضلال وعلى باطل، وإن كنا في هذا المقال لا نشكك في حسن نية المفسرين والفقهاء القدامى، الذين نعتبرهم قدوة في عمق الإيمان وصفاء السريرة وصدق النيّة، بقدر ما ندعو إلى إعادة النظر في قناعاتهم المبنية على النقل بدلا من العقل، وعلى تقليد الآباء بحسن نية دون الرجوع إلى القرآن لتدبّره بعمق وبمنتهى الرشد والحكمة، ما دام القرآن “حياً”، صادراً عن “حيٍّ”، ومُخاطِباً “للأحياء” إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر صورة الواجهة: سطور.