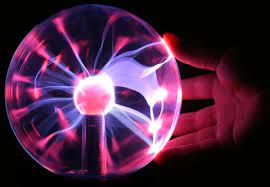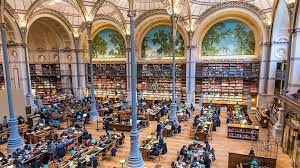الدعاية: مفهومها وأهميتها في المجتمعات الحديثة وأهدافها ووسائلها المتغيرة (مغرب التغيير – الدار البيضاء 27 أكتوبر 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 27 أكتوبر 2023
تحتل الدعاية مكانة مرموقة على الصعيد العالمي بحيث صارت الدول المتقدمة حريصة على إنشاء العديد من المرافق والمؤسسات المختصة بهذه الآلية. ولأن الإنسان يدعو منذ القديم لنفسه من خلال تصرفاته وأنماط سلوكه، فإنه يمكن القول إن الدعاية لها أساس قديم ومتجذّر في الوعي الإنساني منذ البداية. وبالتالي فمن غير الممكن تحديد تاريخ معين نقول إن الدعاية ظهرت فيه لأول مرة. ومن هنا يبدو داعية اليوم مجرد امتداد لداعية الأمس القريب أو البعيد مع اختلاف منطقي في الطرق والوسائل والأدوات. إن الدعاية وسيلة لكسب الناس لفائدة فكرة أو هدف معين. ولذلك فالدعاية الناجحة هي تلك التي تأخذ انتظارات الناس وانشغالاتهم واحتياجاتهم والمفاهيم السائدة لديهم بعين الاعتبار. والدعاية ما هي في حقيقتها إلا “القدرة على التأثير في الناس بطرق غير شخصية من أجل الوصول إلى أغراض معينة.”

نشأتها وتاريخها:
بدا ظهورها بصورة أوضح في الرسالات السماوية باعتبار الرسل والأنبياء دعاةً إلى اعتناق الدين والقبول به. ثم تطورت إلى أن صارت علمًا بين العلوم العصرية والحديثة.
واختلفت التعاريف الواردة في الدعاية بين التعريف الضيق والتعريف الواسع والفضفاض، وبين التعريف الأدبي والتعريف القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي… بحيث يُنظر إلى الدعاية من زوايا مختلفة باختلاف منطلقات المعرِّفين كل من موقعه ونطاق اهتمامه أو تَخَصُّصِه.
ومن بين مَن عرّفوا الدعاية نقرأ أسماء: “جاك أيلول”، و”هارولد لاسويل”، و”ليونارد دوب”… وغيرهم.
ومن أطرف التعاريف، التعريف الوارد في القاموس السياسي السوفياتي، الذي ورد فيه أن الدعاية “شرح مركّز لكتابات ماركس وإنجلز ولينين وستالين، وهي شرح أيضًا لتاريخ الحزب البلشفي (الشيوعي) وأعماله”.
غير أنه من بين عشرات التعاريف التي أصدرها مختلِف المعرِّفين يمكن القول إن هناك ميلاً واسعًا إلى التعريف التالي:
“الدعاية هي فن التأثير والممارسة والسيطرة والإلحاح والترغيب، أو ضمان قبول وجهات نظر أو آراء أو أعمال أو أنماط سلوك معينة من لدن المتلقين.”
وتتميز الدعاية التجارية عن التعريف السابق بكونها “الجهود غير الشخصية التي يُقصد بها توجيه انتباه الزبائن المحتمَلين إلى سلعة معينة وحملهم على شرائها”. فهي بذلك، مكملة للإعلانات التجارية.
ومن مختلف التعاريف يمكن الخلوص إلى الملاحظات التالية:
ـ إن تعاريف علماء الغرب وكتّابه تميل إلى إيجاد كيان للدعاية؛
ـ إن تعاريف علماء البلدان الشرقية، الشيوعية أو الاشتراكية، لا تهتم بإيجاد كيان للدعاية، بل تهتم برجل الدعاية.
ـ إن للدعاية أساليبَ فنّيةً يمكن تحديدها وإن كانت الأنظمة الشيوعية ترى أنها مرتبطة برجل الدعاية (ماركس، لينين، ستالين، إنجلز، باكونين… الخ).
ـ إن للدعاية دومًا هدفًا خاصًا أو أهدافًا معينة قد تكون واضحة وقد تكون غامضة أو خفية.
الاختلافات الجوهرية بين الدعاية والإعلان:
ـ فالدعاية تخفي مصادرها والجهات الكامنة وراءها بعكس الإعلان، الذي يكون معروف المصدر والمنشأ.
ـ والدعاية تلجأ دائمًا إلى التضخيم والتهويل والمبالغة أكثر من الإعلان لأنها لا يهمها اكتشاف الحقيقة ما دام مصدرُها مجهولاً. أما الإعلان فيضع في حسبانه إمكانية العودة إلى مصادره في حالة وجود أي مبالغة أو مغالاة.
ـ والدعاية تلجأ إلى الكذب والتضليل والخداع وتشويه الحقائق وإخفائها من أجل ممارسة التأثير المطلوب، بينما الإعلان يقوم أساسًا على إظهار الفوائد التي يمكن تحقيقها عند اقتناء سلعة معينة واستعمالها أو الانصياع لأمر سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي معين.
ـ والدعاية تميل إلى الإثارة وإحداث الانفعالات، بينما الإعلان يكتفي بجذب الانتباه والترغيب في سلعة أو أمر من الأمور.
ـ والدعاية لا تكتفي بنقل الأخبار عن سلعة أو أمر معين بل تحاول الترويج له أو محاربته بطرق غير شريفة في غالب الأحيان.
ـ والدعاية تقوم بتبسيط الأمور أو تهويلها ولا تبرز إلا المزايا وتخفي العيوب، أو العكس، بحسب الأهداف المسطرة، مما يجعل حكم المتلقي على الموضوع غير موضوعي ويجعل قدرته على التمييز السليم مفتقدة.
ـ وأخيرًا فالدعاية تتجلى في غالب الأحيان على مستوى التعامل النفسي بين الدولة والمواطنين، بينما الإعلان لا يصل إلى ذلك المستوى إلا في القليل من الحالات لأنه موضوعي وقابل للفحص والتقييم.
العوامل الموضوعية والذاتية لظهور الدعاية كنشاط هادف ومنظَّم:
من أهم تلك العوامل:
ـ التطور الكمي والنوعي في وسائل الاتصال؛ ـ نشوء فكرة أو مفهوم “الرأي العام” وتأثره بوسائل الإعلام؛ ـ ظهور الإيديولوجيات الحديثة وأثرها في تعزيز دور الإعلام والدعاية؛ ـ تطور العلوم الاجتماعية والنفسية.
الصعوبات الفنية التي تواجهها الدعاية:
ترجع هذه الصعوبات أساسًا إلى استمرار تطور وسائل الإعلام والدعاية، مما يجعل مواكبتها صعبة، ولذلك تبقى فكرة الإخراج الفنّي للدعاية في تبدُّل دائم ومرتبط بالإمكانيات المتاحة في كل وقت. وهذا يجعل الفكرة التي تبدو بالأمس في شكل معين تتحول اليوم إلى شكل آخر أكثر تأثيرًا، وذلك بسبب تطور طرق الإخراج الفني.
من الصعوبات أيضًا التقيد بالمكان، حيث تتضرر الدعاية مثلاً في الأمكنة التي لا تصل إليها وسائل النشر والبثّ كالأرياف والمناطق النائية.
ويُعتبر عامل الوقت أيضًا من بين الصعوبات المطروحة على العمل الدعائي، كأن يضطر هذا العمل إلى التزامن مع وجود الجماهير المستهدفة في حالة أو موقف لا يسمح لها بتلقي المادة الدعائية، كتجمهرها في منشأة رياضية بعيدًا عن أجهزة الإذاعة والتلفزة المنزلية، أو وجودها في المعامل والمصانع أثناء ساعات البث… الخ.
أما الدعاية التجارية فتعترضها هي الأخرى صعوبات منها على الخصوص:
ـ بالنسبة للوحات المعروضة: لا تستوعب هذه مختلف جوانب الرسائل الدعائية؛ ولا تمكّن من المعرفة الكافية لمواصفات السلعة المعنية، وتكلفتها مرتفعة.
ـ بالنسبة للمذياع: تُبث الدعاية لكافة الناس دون تمييز الفئة المستهدَفة، وتكون في بعض الأوقات بالذات مصدر تشويش، وتكون فقراتها مبثوثة في أوقات محددة قد لا يستمع فيها جمهور عريض.
ـ بالنسبة للتلفزيون: لا يُناسب كافة السلع، وإنما السلع متكررة الاستعمال (كشفرات الحلاقة بالنسبة للذكور، وبعض مواد التجميل بالنسبة للإناث)، ووقوع التضارب بين الدعايات السابقة والحالية واللاحقة، والإرهاق والمضايقة الناجمان عن كثر التكرار.
ـ بالنسبة للسينما: ضآلة زمن العرض، الأثر العكسي للإكراه الذي يتعرض له المشاهد من خلال إجباره على مشاهدة مادة دعائية بينما هو يرغب في مشاهدة الشريط السينمائي الذي جاء إلى قاعة العرض من أجل التمتع بمشاهدته.
ـ بالنسبة للصحف: السرعة في القراءة وعدم اهتمام القارئ بكل الصفحات، وعجزها عن تصميم شكل جيد للدعاية بسبب رداءة الورق وقلة استعمال الألوان، والعمر القصير للجريدة، حيث يُلقى بها إلى القمامة مباشَرةً بعد قراءة غالبًا ما تكون سريعة وغير معمّقة.
ـ بالنسبة للمجلات: صدورها لفترات دورية محددة مما يؤدي إلى تغيير في أسعار المواد موضوع الدعاية أو تغيير في مواصفاتها بما يجعل المجلة تقدم مواد متجاوَزة، زيادة عن ارتفاع تكلفتها.
ـ بالنسبة للرسائل البريدية: إهمال الرسالة في أحيان كثيرة فلا تتم قراءتها، وارتفاع كلفتها، واقتصارُها على عينة قليلة من المرسَل إليهم.
الأشكال التي تنطوي تحتها الدعاية:
1ـ الدعاية الكامنة: ويُطلق عليها تعبير “الدعاية السوداء” لأنها تُخفي مصدرها ولا يكون المتلقون واعين بوقوعهم تحت تأثيرها؛
2ـ الدعاية الظاهرة: ويُطلق عليها اسم “الدعاية البيضاء” لأنها علنية ومنظَّمة ومعروفة المصدر والأهداف والنوايا، ويكون المتلقون عارفين بأن هناك محاولة للتأثير عليهم.
من هنا يتضح أن الدعاية الكامنة هي الأصلح للهجوم وتأكيد القوة الذاتية. كما يمكن استعمال الوسيلتيْن معًا أو إحداهما بحسب الحاجة وكذا الإمكانيات المتاحة.
3ـ دعاية الإثارة المباشرة: وفيها يَعرض الداعية معتقداته وأفكاره مباشرة ويلتزم بالسلوك أو الفكرة التي يعرضها على المتلقين. مثال ذلك: الدعاية التي يقوم بها المصلحون أو الساسة كدعاة الديمقراطية.
4ـ دعاية الإثارة غير المباشرة: وتتميز بالاختلاف بين صاحب الفعل أو القرار والجمهور، الذي يقبل الإثارة ويُذعن لها، بحيث يكون هناك تأثير من ناحية، وامتثال من ناحية ثانية.
5ـ دعاية الكلمة ودعاية الفعل: هذان النوعان يكمل كل منهما الآخر، بحيث تكون النتائج أقل من المستوى المطلوب عند استعمال أحدهما دون الآخر.
6ـ دعاية التحميس والتهييج: تقوم على جذب الانتباه وغالبًا ما تكون مدمِّرة ولذلك تلجأ إليها الحركات الثورية والقوى المتنازعة أثناء الحروب. وتعتبر من أهم أنماط الدعاية الموجهة صوب العامّة أو نحو القاعدة العريضة أو الطبقة الدنيا.
7ـ دعاية الترابط: ويُطلق عليها أيضًا اسم “دعاية التماسك” أو “التوافق”، وهي دعاية طويلة الأمد لأنها تهدف إلى جعل الفرد مساهمًا في كافة مجالات مجتمعه ومتأقلِمًا معه.
8ـ الدعاية الرأسية أو العمودية: وهي التي يكون فيها العمل الدعائي مخططًا وموجهًا من أعلى الهيكل أو الهرم في التركيبة المستهدفة، كأن يكون رجل سياسة أو رئيس أو مقاولة اقتصادية… أي أنها دعاية موجهة رأسيًا من أعلى إلى الأسفل.
9ـ الدعاية الأفقية: وهذه عكس سابقتها، لأنها تتم داخل نفس النسق الجماعي بحيث يكون الفاعلون والمتلقون في نفس المستوى من الهرم الإداري أو المؤسساتي، كما يقع بين خلايا الحزب أو التنظيم الواحد.
10ـ الدعاية المنطقية: وهي الدعاية المعتمدة على أساليب منطقية بحيث تهدف إلى خدمة مصالح مرسليها ومتلقّيها في آن واحد، مع استعمال الأدلة والإثباتات المنطقية والأرقام والإحصائيات الصحيحة.
11ـ الدعاية غير المنطقية: وهي التي تعتمد أساليب وخصائص غير منطقية ولكنها منظمة تنظيمًا سليمًا يهدف إلى التأثير بناء على الدوافع، التي تقلل من أهمية المصلحة الذاتية، كالأدلة غير الصحيحة، والإثباتات المزورة، وتتجنّب المجادلات المنطقية لأنها لا تصمد أمامها، محاوِلةً التأثير على أشخاص يكونون بمثابة أكباش فداء وضحايا لهذا النوع من الفعل الدعائي.
الأساليب المستعملة في الدعاية:
ـ أسلوب استخدام الصور الذهنية، مثل “الاشتراكية”، الرأسمالية”، “السلام”، “الإرهاب”؛ ـ أسلوب استبدال الأسماء والمصطلحات، كاستعمال اسم عاطفي بدلاً من اسم محايد؛ ـ أسلوب الاختيارالموجَّه، كالدعاية الانتخابية القائمة على ذكر الإيجابيات دون السلبيات؛ ـ أسلوب الكذب المستمر؛ ـ أسلوب التكرار؛ ـ أسلوب التأكيد؛ ـ أسلوب معرفة الخصم وتحديده؛ ـ أسلوب الاعتماد على السلطة؛ ـ أسلوب الارتباط الكاذب، كربط الدعاية مع عمل فاضل أو مع مصدر مشهود له، كربط سلعة ببلد صناعي كبير كاليابان دون أن تكون يابانية الصنع. ـ أسلوب إتباع الغير، أو التقليد أو الموضة؛ ـ أسلوب التماثُل، الذي يتم استعماله بين أشخاص متقاربين في جوانب معينة كاللغة.
سمات الدعاية وخصائصها:
ـ أن الدعاية حقيقة وذات كيان؛ ـ أنها علمانية؛ ـ أنها قوية وتوحي بالقوة؛ ـ أن المتلقي ينسب إليها إمكانيات فائقة باعتبار الدعاية من أخطر التدفقات على أي مجال من مجالات استعمالها. ـ الاستفادة من مختلف العلوم والمعارف، مثل علم النفس أو التحليل النفسي وعلم الاجتماع والعلوم الاقتصادية؛ ـ وصولها للفرد من خلال الجماعة، لأنه من المستحيل أن تخاطب الدعاية فردًا فردًا واحدًا بذاته منفصلاً عن غيره؛ ـ وحدتها وشموليتها، فهي تتسرب إلى نفس الفرد من خلال رغباته واحتياجاته، ومن خلال شعوره ولا شعوره أو لاوعيه، ومن خلال عقله وفكره وميوله واتجاهاته، ومن خلال بيئته ومحيطه؛ ـ سيطرتها على الأدب والتاريخ، فكأن التاريخ والأدب تُعاد كتابتهما وفقًا لحاجيات الدعاية من أجل التحكم في اتجاهات المتلقين؛ ـ استمرارها ودوامها، أي عدم انقطاعها عن ميدان عملها الذي هو الجمهور، ولذلك فالدعاية تكاد تكون أبدية؛ ـ تنظيمها السرّي، حيث لجأ معظم الدول إلى تنظيم الدعاية ومأسستها مع الاحتفاظ بسرية التنظيم حفاظًا عليه وعلى سلامة رجاله ونسائه. ـ ميكيافيليتها، حيث الغاية لديها تبرر الوسيلة، بل تبرر كل الوسائل الممكنة والمتاحة؛ ـ وأخيراً كونها تمارس الرقابة في شقيْها الانتقائي والتوجيهي.
الانتقادات الموجهة لأخلاقيات الدعاية:
من أبرز ما يوجه للدعاية في هذا الباب كونها كاذبة ومُغالية ومثيرة لدوافع سلبية كالخوف والشهوة والعدوانية. وهنا ينبغي التمييز بين الدعاية والإعلام، ثمّ بين الدعائيين والمعلنين، حتى لا يقع تعميم هذا النوع من الانتقادات. ففي كل العصور وقعت إساءة استعمال السلطة والنفوذ والمال والجاه، وفي كل العصور أيضًا عمل صُلاّح ومصلحون على بث القيم النبيلة والأخلاق الكريمة. ويمكن القول بعد هذا التمييز إن المعلِن قد يلبس قناع الدعاية لقضاء غرض معين، كإزاحة منافس في السوق أو إقصائه، أو لمواجهة فترة عاصفة في مسار الأعمال، كأن يصف سلعته بكونها الأفضل والأرخص والأكثر نفعًا… الخ، دون السماح لنفسه بتجريح الآخرين أو تبخيس سلعهم ومنتجاتهم، أو القبول بالمحاباة والتحيّز. وهذا يعني وجوب التمييز بين الإعلان والدعاية، وبالتالي بين المعلنين والدعائيين، لأن العنصريْن معًا يمكن أن يُفيدا كما يمكنهما أن يُسيئا إذا أُسيء استعمال أحدهما أو كليْهما، والتاريخ حافل بالأمثلة في هذا الصدد. ولأن الإعلام سلاح خطير وذو حديْن، فإنه يتعين علينا أن نضع ضوابط يحتكم إليها كل من الإعلان والدعاية، ومن تلك الضوابط: قواعد الأخلاق، أو الميثاق الأخلاقي للمهنة أو للعاملين فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: قاعة الانتظار، أرشيف مغرب التغيير.